بضع مرات في كل عام يتم تذكير العالم على نحو ما بأن التهديد بوقوع وباء فتاك بات وشيكاً. ففي عام 2003 كان وباء سارس (SARS). واليوم هناك احتمال انتشار فيروس يصيب الطيور مشابه لذلك الوباء الذي قتل ثلاثين مليون إنسان في أعقاب عام 1914.
لقد أثبت مرض "أنفلونزا الطيور" قدرته على الانتقال من الطيور إلى البشر، والآن أصبح قادراً على الانتقال حتى إلى الهررة، وهو ما يشير إلى أن هذا المرض قد يصبح القاتل العالمي القادم. ولكن هناك العديد من الأوبئة العالمية المحتملة، والعديد منها ليست حتى من الفيروسات. فالبكتريا، والبريونات، والطفيليات، وحتى العوامل البيئية المختلفة، من الممكن أن تتحول على نحو فجائي إلى هيئة فيها هلاك واسع الانتشار للبشر. ومن المرجح، إذا ما حدث ذلك، أن تتجاوز الخسائر في الاقتصاد وأرواح البشر الخسائر التي خلفتها أي من الحروب السابقة التي شهدها التاريخ.
والحقيقة أنه لمما يجعلنا نشعر بتواضعنا وقلة حيلتنا كبشر أن نتذكر أن بعضاً من أشد غزوات التاريخ فتكاً قامت بها كائنات عضوية وحيدة الخلية، مثل الكوليرا، والطاعون الدملي، والسل. وتعمل الدول ذات الموارد على وضع الخطط لمقاومة الأمراض الوبائية ـ وهي في النهاية إستراتيجيات محدودة تستطيع بها أن تحمي مواطنيها فقط. وتأمل أغلب الحكومات أن يؤدي الاكتشاف المبكر إلى تمكينها من احتواء الوباء ومنع انتشاره على نطاق واسع.
وتعتمد خطط الاحتواء اعتماداً شديداً على اللقاحات، لكن اللقاحات لا تشكل أكثر من جزء من الحل. فعلى الرغم من أنها تعد من الدفاعات الجيدة ضد العديد من الفيروسات، إلا أن كل لقاح لابد وأن يكون مصمماً خصيصاً لنوع محدد من التهديدات. والفيروسات عبارة عن كائنات تتطفل على الخلايا، وكل فيروس يهاجم نوعاً معيناً من الخلايا. ويكون الفيروس مصمماً بحيث يستطيع الحفر في جانب معين من الخلية ثم حقنها بأجزاء منه، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك الخلية فيجعلها تنتج المزيد من الفيروسات فتدمر نفسها أثناء هذه العملية. وبسبب الأشكال بالغة التحديد للفيروسات فإن المضاد الأكثر فعالية لأي فيروس لابد وأن يكون مصمما لمواجهة نطاق ضيق من العوامل.
في بعض الأحيان تعمل الطبيعة المفصلة للفيروسات في مصلحتنا. على سبيل المثال، تجد الفيروسات عادة صعوبة في الانتقال بين الأنواع، وذلك لأنها لكي تفعل ذلك لابد وأن تغير هيئتها. ولكن إذا ما كان هناك عائل منتشر على نطاق واسع ـ ولنقل الطيور على سبيل المثال ـ بحيث يحتك بأعداد كبيرة من البشر، فإن الفيروس يستطيع في النهاية أن يجد السبيل إلى التعامل بنجاح مع نمط جديد عليه من الخلايا.
الطيور تعد اليوم المصدر الأعظم لمخاوفنا، فقط لأننا من السهل أن نرى انتشار المرض بينها. لكن فيروس الإيدز انتقل إلينا من القرود، والعديد من أنواع الأنفلونزا انتقلت إلينا من الخنازير. والحقيقة أن التحولات التي تجعل من أي فيروس مهلكاً للبشر لابد وأن يتم إدراكها وتحديدها بصورة عاجلة، حتى يصبح بوسعنا تصميم لقاح فعّال قبل أن تصبح السلالة المتحولة من الفيروس قادرة على التعامل مع الخلايا البشرية بسهولة.
وتصبح هذه الحقيقة أكثر إزعاجاً حين ندرك أن العلماء لابد وأن يراقبوا أيضاً البكتريا، والبريونات، والطفيليات. ومن المعروف أن أنواع البكتريا تتجاوز في أعدادها أي شكل آخر من أشكال الحياة. والعديد من أنواع البكتريا تعيش داخل أجسامنا دون أن تضرنا، بل وتؤدي العديد من الوظائف المفيدة. والبكتريا تتطور وتتكيف بسهولة، وهذا يعني أنها تتعلم كيف تراوغ عقاقيرنا وتتجنبها مع الوقت. وحين ندرس البكتريا يتعين علينا أن نبحث عن نوعين من التحولات: التكيف مع شكل عدائي بحيث تصبح البكتريا قادرة على اكتساب مناعة فائقة ضد العقاقير، أو سلالة متحولة قاتلة قد تظهر في أحد أنواع البكتريا "الآمنة" التي لا تعد ولا تحصى.
أما البريونات فهي تعد اكتشافاً حديثاً نسبياً. وهي عبارة عن بروتينات شبيهة بتلك التي يستخدمها الجسم أثناء الوظائف المعتادة التي يقوم بها الجسم، وهذا يعني أنها قادرة على خداع أجهزة الجسم وحملها على تصنيع المزيد من البريونات. ولم يتم التعرف على البريونات إلا مؤخراً بسبب ظهور العديد من الأمراض المعدية الجديدة، ومنها جنون البقر ومرض كروتزفيلت-جاكوب، وهي أمراض تقتل عن طريق مزاحمة خلايا المخ السليمة. والعديد من أمراض الجهاز العصبي والأمراض التنفسية والعضلية قد تكون ناجمة عن البريونات.
وأخيراً هناك الفطريات، وهي حيوانات بسيطة تصيبنا بالعدوى، ولقد تم تصنيفها بالفعل باعتبارها قادرة على إحداث أمراض وبائية. فالملاريا، على سبيل المثال، تبتلي 300 مليون إنسان، وهي تعتبر أكبر قاتل للأطفال في العالم. والعديد من الطفيليات عبارة عن ديدان: الدودة الخطافية "الأنكلستوما" (التي تصيب ثمانمائة مليون إنسان)، والدودة المستديرة (1.5 مليار إنسان)، وديدان البلهارسيا (200 مليون إنسان)، والدودة التي تسبب مرض الفيل (150 مليون إنسان).
هناك أيضاً العديد من الأعداء التي نتجاهلها في الوقت الحال. فالمواد الكيميائية البيئية والعوالق الدقيقة في الهواء الذي نتنفسه قد يثبت أنها تستحق تصنيفاً خاصاً بها. ولنتأمل المشاكل المركبة الناجمة عن امتزاج هذه الملوثات الكيميائية بحبوب اللقاح التي يحملها الجو، والتي تؤدي بوضوح إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالربو. أما العدوى الفطرية فإنها أكثر ترويعاً، وقد يكون التعامل معها هو الأكثر صعوبة.
الخلاصة هنا هي أننا لا نستطيع أن نتنبأ بمكان نشوء التهديد. أي أننا نحتاج إلى نظام استكشاف ذكي وجيد الانتشار. وإذا ما كنا نريد أن نتحدث بلغة أكثر عملية، فالسؤال هنا هو كيف نبني مثل هذا النظام؟
يتعين أولاً على "الأطباء" أن يكونوا على درجة من الخبرة تسمح لهم بأن يدركوا، إذا ما صادفوا أعراضاً قد تبدو عادية، أنهم في الواقع أمام حالة طارئة. ولابد وأن يكون مثل هؤلاء الأطباء في كل مكان، مع التأكيد على المناطق الأكثر عرضة للتهديد. ففي أغلب الأحوال تظهر التحذيرات الأولية المبكرة التي تنذر بتفشي وباء ما في دول العالم النامي، لكن نقاط الاستكشاف لابد وأن توضع في كل دولة، بأقل قدر ممكن من النفقات. والحقيقة أن هذا الجهد ليس بالصعوبة التي قد يبدو عليها. ويكمن الحل في تسخير وتوظيف البنية الأساسية المتاحة.
إن البنية الأساسية الطبية متاحة في كل مكان على نحو أو آخر. كما أنها في كثير من الأحوال تكون المؤسسات الأقل فساداً في المناطق التي يمثل الفساد فيها مشكلة. ومن المفترض أن نتوقع من المراكز الطبية أن تحقق في أسباب الأمراض التي تصيب عدداً كبيراً من مرضاها، حتى في الحالات التي قد تبدو فيها الأعراض شائعة وعادية. ولسوف يتطلب الأمر إضافة قدر ضئيل من الخبرة العلمية ومعدات المختبرات إلى الأجهزة الصحية المتاحة والتي تخدم الاحتياجات العادية.
إن تعزيز ودعم الموارد المتاحة قد يكون فعّالاً لسببين. أولاً، لأن التقرير الأول عن ظهور مرض ما من المرجح أن يكون صادراً عن مستشفى في مدينة وليس عن معهد متخصص في دراسة مثل هذه الأمراض. وثانياً لأن هذه الاستثمارات البسيطة من شأنها أن تعزز من الأنظمة الصحية المتأخرة في مناطق كثيرة من العالم.
وبالنسبة للمناطق الفقيرة، فإن الاستثمار في المعدات والتدريب لابد وأن يتوفر من قِـبَل جهات أكثر ثراءً. وتستطيع الدول الغنية أن تسوغ النفقات بما تستطيع أن تدخره من وقت وجهد ومال نتيجة للاستكشاف المبكر للتهديدات الصحية الكبرى. وتشكل المناطق ذات المناخ المداري والأحياء الحضرية الفقيرة الجبهتين اللتين يتعين على العالم أن يقاوم فيهما الأمراض الوبائية، ولابد من تجهيز هاتين الجبهتين بالمعدات الملائمة.
تعد الصحة العامة من الأصول المهمة بالنسبة لأي دولة. وإذا كانت التهديدات تكتنف أصولاً على هذا القدر من الأهمية، فمن المنطق والحكمة أن نضع حراساً عند كل مستنقع، ومدينة، وسوق عامة، ومزرعة على وجه الأرض.
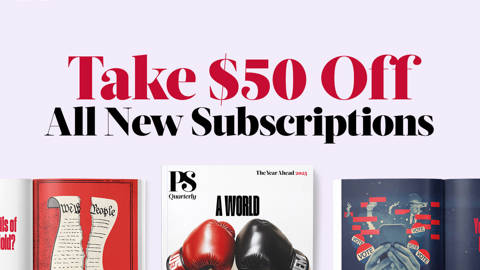








بضع مرات في كل عام يتم تذكير العالم على نحو ما بأن التهديد بوقوع وباء فتاك بات وشيكاً. ففي عام 2003 كان وباء سارس (SARS). واليوم هناك احتمال انتشار فيروس يصيب الطيور مشابه لذلك الوباء الذي قتل ثلاثين مليون إنسان في أعقاب عام 1914.
لقد أثبت مرض "أنفلونزا الطيور" قدرته على الانتقال من الطيور إلى البشر، والآن أصبح قادراً على الانتقال حتى إلى الهررة، وهو ما يشير إلى أن هذا المرض قد يصبح القاتل العالمي القادم. ولكن هناك العديد من الأوبئة العالمية المحتملة، والعديد منها ليست حتى من الفيروسات. فالبكتريا، والبريونات، والطفيليات، وحتى العوامل البيئية المختلفة، من الممكن أن تتحول على نحو فجائي إلى هيئة فيها هلاك واسع الانتشار للبشر. ومن المرجح، إذا ما حدث ذلك، أن تتجاوز الخسائر في الاقتصاد وأرواح البشر الخسائر التي خلفتها أي من الحروب السابقة التي شهدها التاريخ.
والحقيقة أنه لمما يجعلنا نشعر بتواضعنا وقلة حيلتنا كبشر أن نتذكر أن بعضاً من أشد غزوات التاريخ فتكاً قامت بها كائنات عضوية وحيدة الخلية، مثل الكوليرا، والطاعون الدملي، والسل. وتعمل الدول ذات الموارد على وضع الخطط لمقاومة الأمراض الوبائية ـ وهي في النهاية إستراتيجيات محدودة تستطيع بها أن تحمي مواطنيها فقط. وتأمل أغلب الحكومات أن يؤدي الاكتشاف المبكر إلى تمكينها من احتواء الوباء ومنع انتشاره على نطاق واسع.
وتعتمد خطط الاحتواء اعتماداً شديداً على اللقاحات، لكن اللقاحات لا تشكل أكثر من جزء من الحل. فعلى الرغم من أنها تعد من الدفاعات الجيدة ضد العديد من الفيروسات، إلا أن كل لقاح لابد وأن يكون مصمماً خصيصاً لنوع محدد من التهديدات. والفيروسات عبارة عن كائنات تتطفل على الخلايا، وكل فيروس يهاجم نوعاً معيناً من الخلايا. ويكون الفيروس مصمماً بحيث يستطيع الحفر في جانب معين من الخلية ثم حقنها بأجزاء منه، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك الخلية فيجعلها تنتج المزيد من الفيروسات فتدمر نفسها أثناء هذه العملية. وبسبب الأشكال بالغة التحديد للفيروسات فإن المضاد الأكثر فعالية لأي فيروس لابد وأن يكون مصمما لمواجهة نطاق ضيق من العوامل.
في بعض الأحيان تعمل الطبيعة المفصلة للفيروسات في مصلحتنا. على سبيل المثال، تجد الفيروسات عادة صعوبة في الانتقال بين الأنواع، وذلك لأنها لكي تفعل ذلك لابد وأن تغير هيئتها. ولكن إذا ما كان هناك عائل منتشر على نطاق واسع ـ ولنقل الطيور على سبيل المثال ـ بحيث يحتك بأعداد كبيرة من البشر، فإن الفيروس يستطيع في النهاية أن يجد السبيل إلى التعامل بنجاح مع نمط جديد عليه من الخلايا.
الطيور تعد اليوم المصدر الأعظم لمخاوفنا، فقط لأننا من السهل أن نرى انتشار المرض بينها. لكن فيروس الإيدز انتقل إلينا من القرود، والعديد من أنواع الأنفلونزا انتقلت إلينا من الخنازير. والحقيقة أن التحولات التي تجعل من أي فيروس مهلكاً للبشر لابد وأن يتم إدراكها وتحديدها بصورة عاجلة، حتى يصبح بوسعنا تصميم لقاح فعّال قبل أن تصبح السلالة المتحولة من الفيروس قادرة على التعامل مع الخلايا البشرية بسهولة.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
وتصبح هذه الحقيقة أكثر إزعاجاً حين ندرك أن العلماء لابد وأن يراقبوا أيضاً البكتريا، والبريونات، والطفيليات. ومن المعروف أن أنواع البكتريا تتجاوز في أعدادها أي شكل آخر من أشكال الحياة. والعديد من أنواع البكتريا تعيش داخل أجسامنا دون أن تضرنا، بل وتؤدي العديد من الوظائف المفيدة. والبكتريا تتطور وتتكيف بسهولة، وهذا يعني أنها تتعلم كيف تراوغ عقاقيرنا وتتجنبها مع الوقت. وحين ندرس البكتريا يتعين علينا أن نبحث عن نوعين من التحولات: التكيف مع شكل عدائي بحيث تصبح البكتريا قادرة على اكتساب مناعة فائقة ضد العقاقير، أو سلالة متحولة قاتلة قد تظهر في أحد أنواع البكتريا "الآمنة" التي لا تعد ولا تحصى.
أما البريونات فهي تعد اكتشافاً حديثاً نسبياً. وهي عبارة عن بروتينات شبيهة بتلك التي يستخدمها الجسم أثناء الوظائف المعتادة التي يقوم بها الجسم، وهذا يعني أنها قادرة على خداع أجهزة الجسم وحملها على تصنيع المزيد من البريونات. ولم يتم التعرف على البريونات إلا مؤخراً بسبب ظهور العديد من الأمراض المعدية الجديدة، ومنها جنون البقر ومرض كروتزفيلت-جاكوب، وهي أمراض تقتل عن طريق مزاحمة خلايا المخ السليمة. والعديد من أمراض الجهاز العصبي والأمراض التنفسية والعضلية قد تكون ناجمة عن البريونات.
وأخيراً هناك الفطريات، وهي حيوانات بسيطة تصيبنا بالعدوى، ولقد تم تصنيفها بالفعل باعتبارها قادرة على إحداث أمراض وبائية. فالملاريا، على سبيل المثال، تبتلي 300 مليون إنسان، وهي تعتبر أكبر قاتل للأطفال في العالم. والعديد من الطفيليات عبارة عن ديدان: الدودة الخطافية "الأنكلستوما" (التي تصيب ثمانمائة مليون إنسان)، والدودة المستديرة (1.5 مليار إنسان)، وديدان البلهارسيا (200 مليون إنسان)، والدودة التي تسبب مرض الفيل (150 مليون إنسان).
هناك أيضاً العديد من الأعداء التي نتجاهلها في الوقت الحال. فالمواد الكيميائية البيئية والعوالق الدقيقة في الهواء الذي نتنفسه قد يثبت أنها تستحق تصنيفاً خاصاً بها. ولنتأمل المشاكل المركبة الناجمة عن امتزاج هذه الملوثات الكيميائية بحبوب اللقاح التي يحملها الجو، والتي تؤدي بوضوح إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالربو. أما العدوى الفطرية فإنها أكثر ترويعاً، وقد يكون التعامل معها هو الأكثر صعوبة.
الخلاصة هنا هي أننا لا نستطيع أن نتنبأ بمكان نشوء التهديد. أي أننا نحتاج إلى نظام استكشاف ذكي وجيد الانتشار. وإذا ما كنا نريد أن نتحدث بلغة أكثر عملية، فالسؤال هنا هو كيف نبني مثل هذا النظام؟
يتعين أولاً على "الأطباء" أن يكونوا على درجة من الخبرة تسمح لهم بأن يدركوا، إذا ما صادفوا أعراضاً قد تبدو عادية، أنهم في الواقع أمام حالة طارئة. ولابد وأن يكون مثل هؤلاء الأطباء في كل مكان، مع التأكيد على المناطق الأكثر عرضة للتهديد. ففي أغلب الأحوال تظهر التحذيرات الأولية المبكرة التي تنذر بتفشي وباء ما في دول العالم النامي، لكن نقاط الاستكشاف لابد وأن توضع في كل دولة، بأقل قدر ممكن من النفقات. والحقيقة أن هذا الجهد ليس بالصعوبة التي قد يبدو عليها. ويكمن الحل في تسخير وتوظيف البنية الأساسية المتاحة.
إن البنية الأساسية الطبية متاحة في كل مكان على نحو أو آخر. كما أنها في كثير من الأحوال تكون المؤسسات الأقل فساداً في المناطق التي يمثل الفساد فيها مشكلة. ومن المفترض أن نتوقع من المراكز الطبية أن تحقق في أسباب الأمراض التي تصيب عدداً كبيراً من مرضاها، حتى في الحالات التي قد تبدو فيها الأعراض شائعة وعادية. ولسوف يتطلب الأمر إضافة قدر ضئيل من الخبرة العلمية ومعدات المختبرات إلى الأجهزة الصحية المتاحة والتي تخدم الاحتياجات العادية.
إن تعزيز ودعم الموارد المتاحة قد يكون فعّالاً لسببين. أولاً، لأن التقرير الأول عن ظهور مرض ما من المرجح أن يكون صادراً عن مستشفى في مدينة وليس عن معهد متخصص في دراسة مثل هذه الأمراض. وثانياً لأن هذه الاستثمارات البسيطة من شأنها أن تعزز من الأنظمة الصحية المتأخرة في مناطق كثيرة من العالم.
وبالنسبة للمناطق الفقيرة، فإن الاستثمار في المعدات والتدريب لابد وأن يتوفر من قِـبَل جهات أكثر ثراءً. وتستطيع الدول الغنية أن تسوغ النفقات بما تستطيع أن تدخره من وقت وجهد ومال نتيجة للاستكشاف المبكر للتهديدات الصحية الكبرى. وتشكل المناطق ذات المناخ المداري والأحياء الحضرية الفقيرة الجبهتين اللتين يتعين على العالم أن يقاوم فيهما الأمراض الوبائية، ولابد من تجهيز هاتين الجبهتين بالمعدات الملائمة.
تعد الصحة العامة من الأصول المهمة بالنسبة لأي دولة. وإذا كانت التهديدات تكتنف أصولاً على هذا القدر من الأهمية، فمن المنطق والحكمة أن نضع حراساً عند كل مستنقع، ومدينة، وسوق عامة، ومزرعة على وجه الأرض.